لأنّ الحديث هنا سيتّصلُ بالملك عبدالله وابن عبدالله فقد قررتُ إزاحةَ قرويتي مؤقتا رغم أنني لست من متقني كتاب (الآداب السلطانية)..أنا بفضل الله رجلٌ بكاَّء إذا أحببت، ولستُ بِنَكاّءٍ إذا أبغضت.
تجودُ دموعي كلما رأيتُ عبدالله بن عبدالعزيز! وعندما أحاول تبريرها تكثر التبريرات، لكنْ تمرّ أمامي مواقف كثيرة له تجسّدُ الوفاء والكرم العربي الذي يعرفه صفوة العرب الخلّص الباقين على قلّتهم، ومنها: مواقفه ضد عدوه الأول في البلد (الفقر) الذي ما زال في حربه معه، رغم معيقات الفساد الإداري صعبةِ التحريك التي تبدو مستشرية، ومحاولاته المستمرة الصابرة للحرب على هذا الفساد.
وعزمه على اقتحام وسائل الاستنارة في البلد كجامعة الملك عبدالله وبرنامج ابتعاث أكبر عدد ممكن من أبنائنا ليس للعلم التجريدي فقط بل للعلم بما عليه العالم خارج البلد في عتمة الصامدين على الانغلاق داخل أسوار الجهل والظلام.
وتشكيله مؤسسات يمكن أن تؤدي إلى تحريك الفكر الراكد كمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حتى لو تقوقع التنفيذ فيه على نخبٍ لا تستطيع نشر ثقافة الحوار بشكله الذي أراده له عبدالله.
ولم أزلْ أذكر دموع فرحي وبعض صحبي أمام شجاعته النادرة التي أخرجته من مالكِ مُلكٍ إلى مالكِ قلوب ليلة اعتذاره الحضاري الراقي لمنطقتنا (جازان) أثناء زيارته الشهيرة إليها وما تلاها من دفقة تنمويّة ضخمة بدأت بوادر حصادها تظهر لنا هناك. ومواقفه الناصعة العروبة في كثير من القضايا الدولية. وغير هذا كثير.
إن الحبّ الصادق صعبُ التحديد خصوصا لمن يتبوأ مركزاً سلطانيا، فتحديده محتاج إلى قدرة على الموضوعية وعلى سرد مبرراته لمن يفهمون الحبّ فهما نفعياّ ميكافلّياً ويؤمنون بالسؤال: (لماذا أحب؟).
ما أوصلني إلى هذا المدى هو: موقفه من أهلنا في منطقة نجران التي اكتوتْ كجازان وغيرها بنار البعد عن المركز مماّ سبَّبَ بدوره تجاهلا تنمويا أدّى إليه هذا البعد، إضافة إلى نوعيات القيادات الإدارية السقيمة المترهّلة بأسباب متعددة أعرفها ويعرفها الناس جيدا في هذه المنطقة وغيرها، والتي ابتليَتْ بها خلال العقود الطويلة الماضيات.
فموقفه المسؤول حقيقة من منطقة (نجران) لم يكنْ قليلا على مشاعر الناس فيها كما وجدتُ هذا فيهم، ولا أجد الرسالة سهلة أيضا على من يتولى قيادتها الإدارية حاليا.
لقد قرر إهداء فلذة كبده (مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز) إلى قومه الكرام – من أبناء همدان – بما يُعرفُ عنهم من الاعتداد بالمكان والوطن والقيم، ولن يكون على هدية عبدالله سوى أن يحتمل – نيابة عن المُهْديْ – إرثَ تلكم العقود، وأن يحاولَ جاهدا تعويض ذلكم التغييب التنموي بكل الوسائل.. ولعلّ الانطلاقة الثقافية الملحوظة هناك، والتي رادها مجموعة من مثقفي المنطقة وباركها وفرح بها ودعمها وقرر ريادتها الأمير الشاب ومعه الأوفياء لهذا الوطن من أهالٍ ومشاركين في الفعاليات، لعلها الضوء الذي يسبق انطلاق عملية تنموية سريعة تعيضُ هذه المنطقة عن عقودٍ من المراوحة، وهذا ما ظهر لي خلال جولاتي هناك منذُ سنوات ثلاث ومما نعرفه عن إرادة الأمير (هدية أبيه إلى أهله).
سيقولُ الكثير: المنطقة تحتاج إلى المشروعات الاقتصادية التنموية العملاقة أكثر من حاجتها إلى الثقافة التي لا تقضي على بطالة، ولا تنهض بالخدمات إلى مستوى لحاق المنطقة بأخواتها التي عاشت في حضن التنمية المستمرة منذ توحيد الوطن، وبمعنى آخر: الثقافة لا تؤكّلُ الفقير، ولا تؤوي من لا سكن له، ولا تهيّء الطرق بين المحافظات، ولا تعجّلُ بانتهاء الخطوط السريعة بين محافظات المنطقة وبين المنطقة وأخواتها شمالا وغربا! ولا بوصول سكة الحديد، فأقول: الانفتاح الثقافي والمعرفي بهذا الحجم في منطقة من أغنى مناطقنا بالتاريخ يعني انطلاقة إرادة قيادية تنموية تعويضية كبرى تنسينا ما مرّ على مناطق (الأطراف أو النأي) منذ هاتين التسميتين المشؤومتين اللتين كانتا تطلقان على بعض مناطق الوطن ولم تزل في خلد البعض وللأسف.. رؤيتي التي وجدتها هي: إرادة جوهرية يحملها الأمير منذ ولاّهُ وأهداهُ ملك الحبّ منطقةً لا ندّعي أننا -أو أحدا منا- نجهلُ تاريخها النقي، ولا تاريخها الجامد مع قادة إداريين همّشوها وهمّشوا أكفاءً من أهلها لأسباب تخضعُ لرؤى صغار العامة ولا تقنع قمة القيادة.. وأملي معهم أن تكون هذه القفزة الإعلامية والثقافية التي حظيت بها (رجْمَتْ) التاريخ قفزةً شاملةً يقودها أميرها الذي يثق الكل في إرادته.



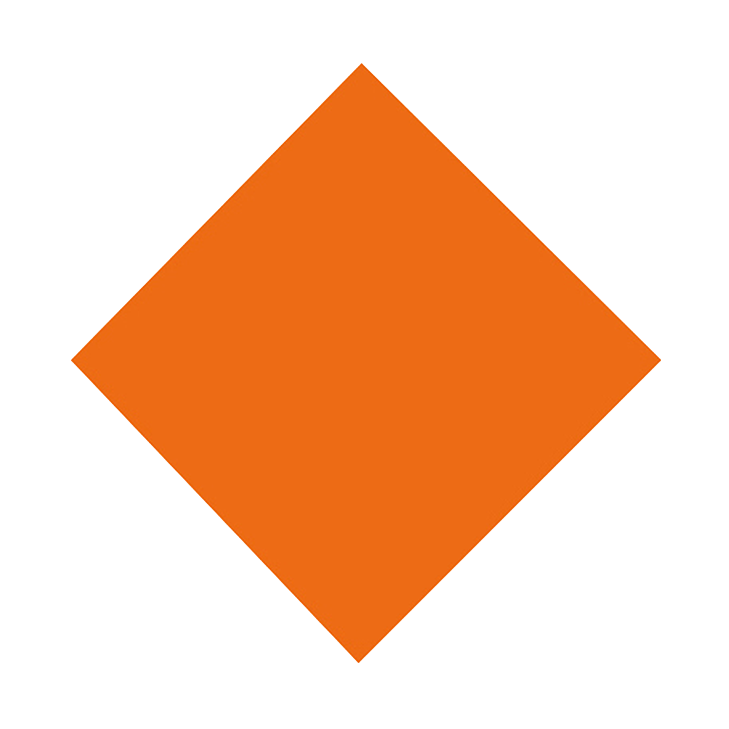




















 أقسام النادي
أقسام النادي روابط مهمة
روابط مهمة للتواصل معنا
للتواصل معنا لمحة عن النادي
لمحة عن النادي مواقع التواصل
مواقع التواصل